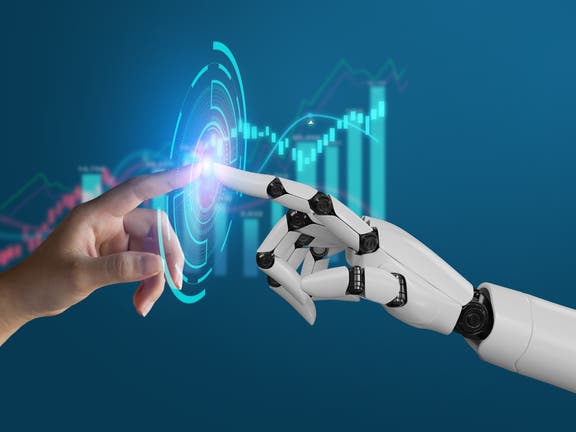
سعيد ناشيد و وفاء مليح يطلقان نداء الخطوة الحرة دفاعا عن الإنسان
تعيش الحضارة الإنسانية اليوم منعطفا تاريخيا فارقا، يضعها أمام مفترق طرق مفصلي، وأمام أسئلة شائكة حول تداعيات كل من الرقمنة الشاملة والذكاء الاصطناعي، على هوية الإنسان، تماسك المجتمعات، ومصائر النوع البشري.
وإذ تحمل التكنولوجية فائقة التطور كثيرا من الآمال للتنمية والسلام، فإنها تحمل في المقابل مخاطر التدهور الحضاري وتفشي بعض أشكال الهمجية والتوحش.
لا ننكر أن من طبيعة الطفرات البشرية أن تثير من المخاوف قدر ما تثيره من الآمال، وأن مخاوف كثيرة كانت تتبدد تلقاء نفسها مع مرور الزمن، إلا أن هناك نكسات مدمرة رافقت أرقى مظاهر التطور الحضاري، فمن أعلى مظاهر العلم خرجت القنبلة الذرية، ومن أعلى مظاهر الصناعة والإدارة خرجت الأنظمة الشمولية والاستعمارية، وذلك ما يحدث عندما يضعف البعد الإنساني في الإنسان.
إن كان ستيفن هوكينج يحذر من “أن تطوير الذكاء الاصطناعي يمكن أن يتسبب في نهاية الجنس البشري، طالما البشر مقيدون بالتطور البيولوجي البطيء، ولا يمكنهم التنافس مع الآلات التي تعيد برمجة ذاتها بسرعة”، فمن المؤكد أن التطور التكنولوجي في ظل مجتمعات تسود فيها أجواء التصحر الثقافي قد يؤدي إلى انحطاط كل ما هو إنساني في الإنسان.
التكنولوجية التي تجعل الإنسان اليوم يختصر كثيرًا من الجهد المعرفي والتواصلي والحركي، قد تجعله في المقابل يستغني عن مهارات هي مكسب آلاف السنين من التطور، وقد ينجم عن ذلك كله ضمور بعض جوانب فاعلية الإنسان. يقال، العضو الذي لا يعمل يموت، أفلا يُخشى أن تضمر الأبعاد الإنسانية في الإنسان حين تتوقف عن الاشتغال؟
إن المطلوب هو أن تعمل أبعاد الإنسان كافة وباستمرار، وذلك لئلا تضعف أمام فاعلية التكنولوجيا المتطورة، على أنّ ميدان العمل الأساسي لأجل الحفاظ على ما هو إنساني في الإنسان هو الحقل الثقافي بالذات، باعتباره قوة ناعمة للتنمية والأمن والسلام.
الثقافة هي النشاط الذي من خلاله ينحت الإنسان نفسه بنفسه، وهي فرصته للنمو الوجداني والسمو الغرائزي والارتقاء الحضاري، إنها أكسير الكينونة في النهاية. ومن ثم سيكون الاستثمار في مجالات القراءة والكتابة والرسم والنحت والموسيقى والمسرح والسينما، بمثابة استثمار في الإنسان لأجل الإنسان.
إن تطور تكنولوجية التواصل والاتصال الذي فرض تغييرا شاملا في نمط حياة جميع الناس، قد أصبح يسائل مستقبل أهم مؤسسات الدولة الحديثة، على رأسها الحزب، النقابة، المدرسة، الجامعة، والإعلام، كما يسائل موقع الثقافة والمثقفين سواء على الصعيد الوطني، الإقليمي، أو الدولي، ويطرح بالموازاة تحديات غير مسبوقة أمام وظائف الذكاء البشري، وأدوار الرأسمال الرمزي، لغاية تحقيق معادلة الأمن والتنمية والسلام.
لا ننكر وجود آمال كبيرة تحملها آليات التواصل والاتصال الجديدة، من حيث القدرة على توفير فرص أفضل للمعرفة، العمل، الاكتشاف، والإبداع، وبالتالي المساهمة في بناء مجتمعات مفتوحة، إلا أنها لا تخلو من كوابح قد تعيد الكثيرين إلى دائرة التقوقع. فبقدر ما تفتح التقنيات الجديدة الباب أمام التعارف والتقارب بين الثقافات، فإنها تعيد إنتاج الانغلاق عبر خوارزميات تقترح على الناس علاقات وخدمات تعيدهم إلى دائرة اهتماماتهم الضيقة، كما أن وسائل التواصل الاجتماعي التي تمنح الفرد قسطا من الفاعلية في مجريات الأمور، قد تنمي في المقابل غرائز القطيع من خلال حملات الكتائب الإلكترونية التي كثيرا ما تقلب الموازين بنحو فجائي، وقد تدفع بفاعلين غير متوقعين إلى مسرح الأحداث، مما يضطر الجميع إلى التعايش مع هامش الانفلات الذي هو من صميم كل الفترات الانتقالية.
والحاصل أن هامش الانفلات الملازم بالضرورة لمجتمعات الانتقال الديمقراطي، قد اتسع بفعل صيرورة الانتقال الرقمي، وهو الوضع الذي أتاح لكل فرد فرصة أن يصير “مؤثرا” ضمن سياقات يصعب التكهن بها.
إن هذا الواقع الذي لا يزال في طور الحدوث، ليجعل من تنمية الذكاء العمومي في كل أبعادها الفكرية والوجدانية حاجة أمنية وضرورة تنموية للمجتمعات كافة، لا سيما وأن مركز ثقل العملية التنموية آخذٌ في الانتقال من طور الإنتاج المادي إلى طور الإنتاج اللامادي، موازاة مع انتقال مركز ثقل الحضارة المعاصرة من العقل الأداتي إلى العقل التواصلي، وهو الوضع الذي يمنح للأفكار والثقافة والجمال دورا أكبر في تماسك المجتمعات وقدرتها الذاتية على تحقيق النمو والأمن والتنمية.
كما لا ننس الدور الذي أمسى مطلوبا من الدبلوماسية الثقافية لغاية تحقيق التقارب المنشود بين مختلف الدول والمجتمعات، سواء في الأبعاد الفكرية، المعرفية، أو الجمالية.
لقد اختارت معظم الدول المتقدمة التشجيع على إنشاء مراكز لإنتاج الأفكار، وذلك وعيا منها بأن قوة الدفع التنموي تقاس بجودة الأفكار التي يتم إنتاجها كل يوم في كل مجالات الحياة، وأن تدبير الذكاءات يمثل أحد أكثر مجالات التدبير أهمية.
أمام هذه التحديات والرهانات، فإن المقاربات المالية التقليدية التي كانت تضع دور المثقف على الهامش، لكي يحتضنه إما اليسار الجذري أو حانات التسكع، قد أصبحت عاجزة عن تلبية حاجيات عصر أصبح فيه كل مواطن يمتلك مكبر صوت ليقول أي شيء، وبالتالي ففي ظل الخيار الديمقراطي الذي لا رجعة عنه، سيكون أمامنا طريقان، أما أن نترك كل مواطن يقول أي شيء في انتظار اقتناص أخطائه وخطاياه قبل إسكاته، أو أن نعلمه كيف يقول؟ وقبل ذلك، كيف يفكر؟ كيف يختبر مشاعره؟ كيف يغذي خياله؟ كيف يتعاطف بمشاعر إيجابية؟ كيف يتطلع إلى المعرفة بشغف؟ كيف لا يقبل أن يتعرض عقله للخداع والتضليل؟
في عصر الانتقال الرقمي، الذكاء الاصطناعي، وأجهزة التواصل الحديثة، سيكون الجهل المعرفي، والغباء العاطفي، والقابلية للتضليل والخداع، بمثابة عوائق كبرى أمام مشاريع الأمن والتنمية والسلام.
وعيا بذلك كله، وتماشيا مع الأوراش التنموية التي يشهدها بلدنا المغرب، لا سيما فيما يخص البنية التحتية، واستحضارا لدور الثقافة في تنمية القيم الأساسية، فإننا في نداء الخطوة الحرة، ندعو مؤسسات الدولة المعنية بالشأن الثقافي إلى ما يلي:
– رعاية الحقل الثقافي في أبعاده الفكرية والأدبية والعلمية بكل الجدية المطلوبة، وفق رؤية استراتيجية واسعة المدى وطويلة الأمد، وذلك بمعزل عن الحسابات السياسوية الضيقة التي ترعى “مشاهير نسب المشاهدة العابرة”!
-العمل على الإصلاح التربوي على أساس إدماج الرقمنة والذكاء الاصطناعي وفق مناهج تركز على تنمية الذكاء التركيبي، الذكاء العاطفي، وملكة الخيال.
-العمل على الإصلاح اللغوي على أساس تبسيط واختزال قواعد اللغة العربية، وبما يتماشى مع حاجيات الانتقال الرقمي.
– فتح وسائل الإعلام الرسمية وشبه الرسمية على النقاش الثقافي والفكري بإخراج فني وتواصلي يشدّ الجمهور ويوجه النقاش العمومي، تماما مثلما تفعل بعض الفضائيات الرائدة باحترافية، وذلك بعيدا كل البعد عن أكذوبة “هذا ما يحبه الجمهور”!
– إعادة النظر في فلسفة وسياسة الجوائز الفكرية والأدبية، والتي على شحها وضحالتها، فإنها لا تخدم الإنتاج الثقافي كما ينبغي أو كما يُفترض.
– منح كل قطاع من قطاعات الوظيفة العمومية نسبة محددة لغاية التفرغ للعمل الثقافي، أسوة بالتفرغ النقابي والسياسي والجمعوي، وذلك وفق معايير ولوائح يتم تحديدها ومن ثم تحيينها كل عام، بناء على الإنتاجية والمردودية كذلك.
-مراجعة معايير وطرائق تقييم عمل مراكز الدراسات، بنحو يحفزها على إنتاج الأفكار الجديدة، واقتراح المبادرات غير التقليدية، مع إشراف أكاديميين عريقين ومتعددي التكوين على مساطر التقييم والمحاسبة، على اعتبار أن الإنتاج اللامادي له معاييره الخاصة.
– إعطاء الاعتبار لكل أشكال الإبداع الفكري والأدبي والعلمي والمعرفي والفني، انسجاما مع التحولات العالمية الجارية، وتقديرا للرؤية الملكية المعبر عنها منذ عام 2014 والتي تنص على أهمية” احتساب الرأسمال غير المادي كمكون أساسي”.




